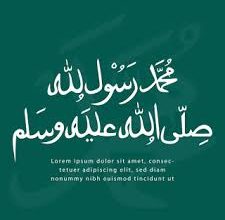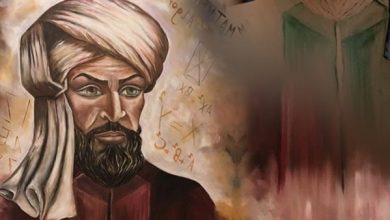(لَيَكُونًا ـــ لَنَسْفَعًا).. سِرُّ رَسْمِ نُونِ التَّوْكِيدِ الخَفِيفَةِ ألِفًا في العَرَبيَّةِ والعِبْرِيَّةِ

أَصْلُ الخَطِّ العَرَبِيِّ والخَطِّ العِبْرِيِّ وَاحِدٌ، وهُوَ الخَطُّ الفِينِيقِيُّ، وكَانَ الفِينِيقِيُّونَ يَعِيشُونَ شَمَالِيَّ بِلَادِ الشَّام، وعنهم أخَذَتِ اللُّغَةُ العَرَبيَّةُ والعِبْرِيَّةُ والآرامِيَّةُ خَطَّهَا، وكانَتِ الكَلِمَاتُ تُكْتَبُ حُرُوفًا مُنْفَصِلَةً غَيْرَ مَوْصُولةٍ، كنِظَامِ الكِتَابَةِ في اللُّغَةِ العِبْرِيَّةِ إلى يومنا هذا، فَضْلًا عن إهمال كتابة حُرُوف المَدِّ، وعدم وجود رمز للحركات الثلاث الضَّمَّة والكسرة والفتحة، وعدم وجود رمز للسُّكُون والشَّدَّة والهمزة.
وقد أَخَذَ العَرَبُ القَاطِنُونَ في (مَدَائن صالِح ـ الحِجْر ــ مُحافظة العُلا بالمملكة العَرَبِيَّة السُّعودِيَّة) الخَطَّ العربيَّ عن الحضارة النَّبَطِيَّة العَرَبِيَّة في شَرْقِيِّ الأردن منطقة البَتْرَاء الآنَ، الَّذِينَ أخَذُوا خَطَهُمْ عن الآرَامِيِّينَ الَّذين كانون يعيشون شَرْقِيَّ الأردن، وقد أخذَ الآرَامِيُّون خَطَّهُمْ عن الفِينِقيِّينَ، وهذا رأي علماء النُّقُوش العربيَّة القديمة من أصحاب البعثات الأوربيَّة الحديثة وعلماء جامعة الملك سُعُود بالرِّياض، وثَمَّةَ رأيٌ آخَرُ للدكتور مِشَلَّح بن كميخ المِرِيخي الأستاذ بجامعة الملك سعود، ذكره في ندوة بمجلس وادي القُرى الثقافيّ بالعُلا منذ شهور معدودات ، يرى أنَّ العرب أخذوا خَطَّهُمْ مُباشرةً عن الحضارة الفِينِيقِيَّة مُنْذُ حَوَالي ألفي سنة تقريبًا، ، ثُمَّ حَدَثَ تَطَوُّرٌ للخَطِّ العَرَبِيِّ عَبْرَ الزَّمَان، فصارَ موصولًا، وتَغَيَّرَ رَسْمُ حُرُوفِهِ عن الأصْلِ القَدِيم عبر الزمان، حتَّى وَضَعَ أبو الأسود الدُّؤَلِيُّ نَقْطَ الإعراب، ثُمَّ وَضَعَ تَلامِذَتُهُ نَقْطَ الإعْجَام، ثُمَّ طَوَّرَ الخليلُ الفراهيديُّ ذلك، فَوَضَعَ رمزَ حركات الإعراب ورمزَ الشَّدَّة ورمزَ السُّكون ورمزَ الهمزة و ورمزَ الألف الفارِقَة بين واو الجماعة و واو الفِعْل، وغير ذلك مِمَّا سُمِّيَ بشَكْلِ الخليل.
ولكنْ بَقِيَ بَعْضُ آثارِ الكتابةِ العربيَّة القديمةِ، كرَسمِْ النُّونِ الخَفِيفَةِ أو رَسْمِ نون التوكيد الخَفِيفَة، الَّتِي كانَتْ تُرْسَمُ قديمًا ألفًا في نُقُوش الحِجْر و في نُقُوش العَصْر الجاهلِيّ ومخطوطاته كالمُعَلَّقات السَّبْع والعَشْر، وفي نُقُوش العَصْر الإسلامِيّ و المخطوطات العربيَّة القديمة في عهد الرسول ﷺ، والخلفاء الرَّاشدينَ والعصر الأمويّ، وتلك النُّقُوش الموجودة في المدينة المنورة وغيرها الَّتِي كُتِبَتْ في العصر الجاهليّ والإسلاميّ، يقوم الآنَ على جمعها ودراستها علماء جامعة الملك سُعُود والبعثات الأجنبيَّة مَعًا؛ وبناءً على ذلك فلدينا مصدرانِ رئيسانِ للخَطِّ العربيِّ القديمِ النُّقُوشُ “كلية الآثار بجامعة الملك سعود بالرياض”، والمخطوطاتُ “مخطوطات تركيا ولندن وليدن وباريس ودار الكتب المصريَّة والمكتبة الظاهريَّة بدمشق ومكتبات الإمارات العربيَّة ومكتبة المسجد النبويّ الشريف ومكتبات اليمن ومكتبات المغرب والجزائر وتونس والعراق وغير ذلك مِن المكتبات الَّتي بها مخطوطات عربيَّة”، فالأمر يحتاج إلى استقصاء كامل، وليس ذلك في وُسْعِي؛ فذاك جُهْد مُؤسَّسات دوليَّة كُبرى، وحَسْبِي الآنَ أنْ أقول: إنَّنِي اطَّلَعْتُ على بعض الأدلَّة مِنَ النُّقُوش العربيَّة والمخطوطات العربيَّة الَّتي رُسِمَتْ فيها نونُ التوكيد الخفيفة ألفًا.
وثَمَّةَ قاعِدَةٌ لُغَوِيَّةٌ ثابتَةٌ في كُلِّ اللُّغَات، ترى أنَّ الظاهرة اللُّغويَّة أو الإملائيَّة الكتابيَّة، لا تَنْمَحِي تمامًا مَعَ تَطَوُّر الزَّمان، بَلْ تبقى منها بعضُ الأمثلةِ شاهِدًا عليها، وقد أَطْلَقَ عليها عالمُ اللُّغاتِ السَّاميَّةِ أُسْتَاذُنَا الدكتور رمضان عبدالتواب ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ت أغسطس 2021م ــ مُصْطَلَح “الرُّكَام اللُّغَوِيّ” في كتابه “بحوث ومقالات في اللُّغَة”، وذكرَ هذه القاعدةَ قبله العلماءُ الغربيُّونَ كفندريس و برجشتراسر وبروكلمان و شبيتالر وفيشر وليتمان ويوهان فك وغيرهم، وقد درسها علماء العربيَّة القدماء تحت مُسَمّى “الإبقاء “التصحيح” مع وجود مُوجِب الإعلال”، نحو: “اسْتَنْوَقَ واسْتَحْوَذَ واسْتَتْيَسَ”.
ومِنْ هنا فظاهرةُ الرُّكامِ اللُّغَوِيِّ قاعدةٌ علميَّةٌ ثابتةٌ لُغَةً وكِتَابَةً، وذلك ما يظهرُ لي في تفسيرِ سِرِّ رَسْمِ نُونِ التوكيدِ الخفيفةِ ألِفًا في القرآن الكريم في قوله تعالى: (وَلَیَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ) سورة يوسف12/32، و قوله تعالى: (لَنَسْفَعًا بالنَّاصِيَةِ) سورة العلق96/15، وفي القافية في الشِّعْر العَرَبيّ، تُرْسَمُ نونُ التوكيد الخفيفة ألِفًا، وتُنْطَقُ ألِفًا، فهذا بقايا رَسْمِ النُّونِ الخفيفةِ ألِفًا في الخَطِّ العربيِّ القديم، حافظَ عليه الرَّسْمُ العُثْمَانِيُّ للمُصْحَفِ الشَّرِيف، فصارَ رَسْمُ نُونِ التوكيدِ الخفيفةِ ألِفًا في المُصْحَف عَزِيزًا عندَ المُسلِمينَ، وهذا الرَّسْمُ للنُّونِ الخفيفةِ ألِفًا موجودٌ في اللُّغة العِبْرِيَّة وَقْفًا ووَصْلًا ،و كِتَابَةً ونُطْقًا.
وقد “ذكرَ علماءُ اللُّغَات السَّاميَّة المُقارنة، أنَّ توكيد الفِعْل المُضارع والأمر بالنُّون، مُسْتَعْمَلٌ في اللُّغَةِ الأكَّاديَّةِ والعِبْرِيَّةِ، ونادِرٌ في اللُّغَةِ الآرَامِيَّة، كما ذكروا أنَّ اللُّغَة الأكَّاديَّة تَسْتَعْمِلُ حَرْفَ المِيمِ لا النُّونَ في التوكيد، كما ذكروا أيْضًا أنَّ اللُّغَة العِبْرِيَّة سادَتْ فيها صورةُ الوَقْفِ بالألف مع النُّون الخفيفة وَقْفًا ووَصْلًا، لذا تُرْسَمُ النُّونُ الخَفِيفَةُ فيها ألِفًا كِتَابةً ونُطْقًا، مثال hubbite= اُنْظُرَنْ، وأمَّا النُّون الثقيلة، فهي مع الضمائر المُتَّصِلَة فَقَطْ” .
وليسَ الأمْرُ في رَأْيِي كما يقولُ علماءُ كُتُبِ تجويدِ القرآنِ الكريمِ في تفسير رَسْم نُون التوكيدِ الخفيفة ألِفًا في قوله تعالى: ( وَلَيَكُونًا) و (لَنَسْفَعًا) في سُورَتَي يوسف12/32 ، والعَلَق96/15: “إنَّهَا رُسِمَتْ على الوَقْفِ”، فليسَ فيها وَقْفٌ في المَوْضِعَيْنِ؛ بَلْ فيها وَصْلٌ وإدْغَامٌ النُّونَ في المِيمِ في سُورة يُوسُف، وفيها وَصْلٌ وإقْلَابٌ النُّونَ مِيمًا في سُورة العَلَق،.ومِنْ هُنَا إذا سَقَطَ الدليلُ، سَقَطَ مَعَهُ الحُكْمُ، فما دامَ دليلُ الوقفِ في المَوْضِعَيْنِ غيرَ موجودٍ، فلا حُكْمَ بأنَّ نون التوكيد الخفيفة، رُسِمَتْ ألِفًا على الوَقْفِ.
وإذا كانت اللُّغَةُ العربيَّةُ تَقِفُ على النُّون الخفيفة بالألِفِ، فكذلك تَقِفُ اللُّغَةُ العربيَّةُ على نون التنوين المنصوب في القرآن والشِّعْر والنَثْر بالألفِ نُطْقًا وكِتَابةً، فيُرْسَمُ التنوينُ في الوقفِ ألِفًا، ويُنْطَقُ أيْضًا ألِفًا، إذا كان الاسمُ نكرةً منصوبًا مصروفًا، وكذلك يحدث في اللُّغة العبريَّة، فالكتابةُ والنطقُ والاستعمالُ النحوِيُّ للنُّون الخفيفة يكون ألفًا.
وأمَّا اللُّغَة الأكَّادِيَّة فتستعملُ في التَّوْكِيدِ حرفَ الميمِ بدلًا مِنَ النُّون، وربَّما تكون الميمُ في اللُّغَة الأكَّاديَّة مُحَوَّلةً مِنَ النُّون في العربيَّة والعبريَّة والآراميَّة، أو هما النُّونُ والميمُ أصلانِ، ومعروفٌ أنَّ النُّونَ والمِيمَ صَوْتَانِ أنْفِيَّانِ مَجْهُورَانِ، غير أنَّ الميمَ صوتٌ شَفَوِيٌّ، والنُّونَ صوتٌ لِثَوِيٌّ . واعتمادًا على إدغام النون ميمًا، وإقلاب النون ميمًا في تجويد القرآن الكريم، أرى أنَّ الميمَ الأكَّاديَّة مُحَوَّلةٌ عن النُّون العربيَّة الأصليَّة غالبًا.
وأيْضًا يُفَسِّرُ لنا الرُّكامُ الإمْلَائِيُّ سِرَّ رَسْمِ كلمة (إذا) حرف جواب وجزاء بالألف، مع نطقها نُونًا، فقد حافَظَ لنا الرَّسْمُ العُثْمانيُّ الشَّرِيفُ للمُصْحَفِ الشَّرِيفِ على هذا الأثرِ الكتابيِّ العربيِّ القديمِ في حال الوَصْل والوَقْف مَعًا،وكذلك مخطوطات الشِّعْر العربيّ القديم وشواهد النَّحْو الشِّعْرِيَّة لكلمة (إذا) الجوابيَّة.
وَمِمَّا سَبَقَ ذِكْرُهُ فَقَد اعْتَمَدْتُ في رَأْيِي هُنَا عَلَى ثَلَاثَةِ أدِلَّةٍ عِلْمِيَّة، الأوَّل: النُّقُوش العَرَبِيَّة، والثاني: المَخْطُوطَات العَرَبِيَّة، والثالث: فِقْه اللُّغَات السَّامِيَّة المُقارنة.
واللهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ والسَّدَادِ